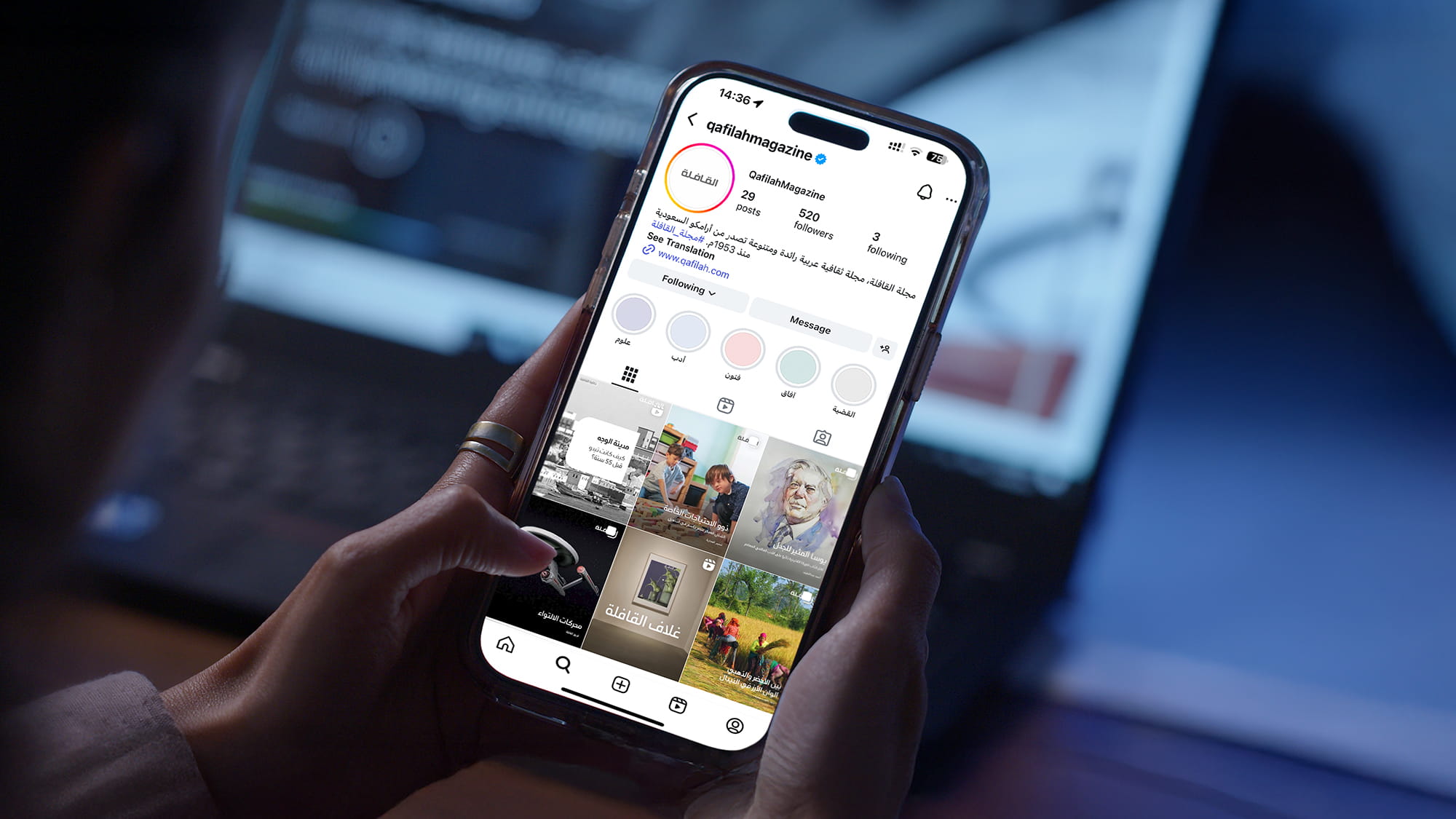تحوُّلات ”التِتر" من هامش الدراما إلى مركزها
في زمن ليس ببعيد كانت شاراتُ الدراما التلفزيونية شبيهةً بالأبواب الخشبيّة القديمة: بسيطة وعتيقة لكنها تدل على البيت وأهله. تلاشت البيوت اليوم في عصر الزحمة الإعلامية والضجيج الرقمي. وأصبحت الشارَةُ أداة صيد في بحر لا يهدأ. عليها أن تلفت الانتباه بأي ثمن. عليها أن تنجو من الأغوار الخوارزمية الشرسة التي لا تمنح العمل أكثر من خمس ثوانٍ قبل أن تنفيه بنقرة واحدة إلى أسفل الشاشة، حيث جحيم الفرجة والربع الخالي من المشاهدين.
لا يختلف المشاهد العربي عن غيره في سائر بلاد العالم. فبحسب باحثين من جامعة كاليفورنيا، أكثر من %70 من مشاهدي العالم يُقيّمون العمل من "التِتْر"؛ أي من العنوان الافتتاحي في العمل الفني الذي يتضمن عنوان الفيلم وأسماء العاملين فيه. فما العناصر الجوهرية التي ظلَّت راسخة في "التِتْر" بصفتيه: مفهومًا ومنجزًا. وما العناصر التي تغيّرت؟
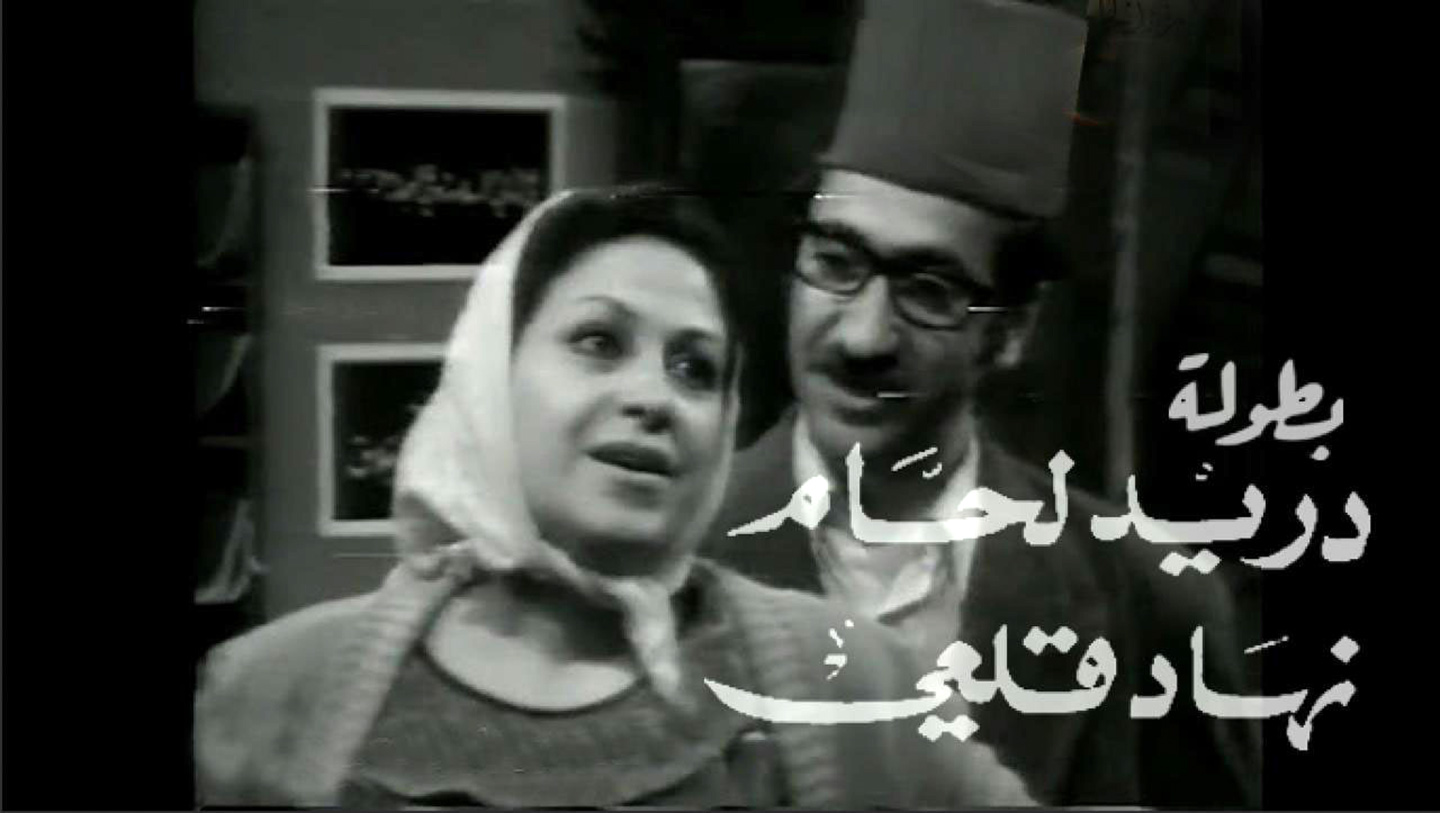
مسلسل صح النوم (1972م)
ثوابت لم تتغيَّر منذ تلفزيون الأسود والأبيض
التِتر هو البوابة الأولى للعمل، وصيحة الإعلان عن بداية طقس الفرجة. إنه اتّفاق جماعي على ترك ما في اليد والانتباه، ووقت مستقطع من الحياة العادية. إنه تعبير بهيج عن الرغبة في تقاسم مُتعة مع أفراد الأسرة وأبناء العمّ والجيران، ولحظة مُختصرة تشير إلى مستقبل الحكاية وتصنع لها ماضيًا مشتركًا. ومن ثَمَّ، يمنح الدراما التلفزيونية عنصرًا تتميَّز به عن الدراما الأدبية: مستوى لغوي قادر على أن يروي قبل أن تبدأ الرواية. وهذا ما جعل التونسيّين مثلًا، يفتتنون بمسلسل "أمّي تراكي" عند ظهوره في عام 1968م.
لم يكن ثمَّة اهتمام بوضع الموسيقى في ذلك الوقت. لم يكن التِتر إنجازًا جرافيكيًّا، ولا أغنيةً بالمعنى التقني للعبارة. كان مجرَّد ميلودي ذكية أدى فوقها ممثلو المسلسل بالتناوب جُملةً سرعان ما أصبحت أيقونية: "أمّي تراكي ناس ملاح". ويكفي اليوم أن يسمع أطفال ذلك الجيل النوتات الأولى حتى يستحضروا كوكبة من ألمع نجوم التمثيل الذين أنجبتهم تونس من أمثال: الزهرة فائزة، وصالح المهدي، ومنيرة بن عرفة، ومحمد بن علي، ودلندة عبدو، والقائمة تطول.
"التِتْر" وسيلة لإنتاج الألفة
وهذه من الصفات الثابتة أيضًا، سواء تعلَّق الأمر بالمسلسل الأمريكي "صراع العروش" (2011م)، أو بالمسلسلات العربية القديمة التي كانت بالأسود والأبيض في الستينيات والسبعينات، مثل المسلسل السوري "صحّ النوم" (1972م)، تحفة دريد لحام ونهاد قلعي، حين كان ظهور غوّار الطوشي كافيًا لإدارة الأعناق والوعد بضحكة ذكية لمًّاحة؛ أو المسلسل اللبناني "فارس ونجود" (1974م)، حين كان القلب مع فارس (محمود سعيد)، لكن العين على نجود (سميرة توفيق) صاحبة الجمال الأخَّاذ والصوت البدوي الصادح، بطلة العمل ومؤدّية أغانيه وتِتره (كلمات موفّق شيخ الأرض وموسيقى محمد محسن).
يقوم التِتر، بصفته هذه، مقام توقيع الكاتب بالنسبة إلى القارئ. إنه ميثاق أبوّة وتأكيد بنوّةٍ وإعلان نَسب. وهو بناء للتوقُّع أيضًا. تسمعه فتتداعى في ذاكرتك مشاهد، وتنفتح مخيّلتك على لحظات معينة. تستحضر فريق العمل، وتسترجع القصة. تتذكَّر "زمن المشاهدة"، ومع مَن شاهدتَ العمل؟ وأين؟ هكذا يكون قد أنتج أُلفتَكَ مع أحداث المسلسل وشخوصه، لكنه ألَّف بينك وبين زمانك ومكانك أيضًا.
منصة إطلاق للدهشة
هذه إحدى الثوابت أيضًا. وهي تتطلَّب تأليفًا بين ثلاثة عناصر: الإخراج البصريّ الجرافيكي المحسوب، والموسيقى القادرة على إيقاظ الأحاسيس بما يحفر في الذاكرة ويحفّز الخيال، والتكثيف القادر على مدّ جسور بين الواقع والرمز بما يُحقِّق المصداقية الفنية.
والحقُّ أن الدهشة تزداد صعوبة مع تقدُّم الإنسان في عمره. ولكن مع تقدُّم الإنسانية في عمرها التكنولوجي، أصبحت "المؤثرات الخاصة" والتكنولوجيا الرقمية قادرة على تنفيذ ما لا يخطر ببال. فلعلَّك تبتسم حين تذكر دهشتك بسلسلة "ستار تراك" (1970م)، أو سلاسل "مارفيل" المختلفة. غير أن من الصعب إعادة إنتاج تلك الهزَّة التي عرفها المتفرِّج مع انتقال التلفزيون إلى زمن الألوان. كان الأمر نوعًا من الإحساس الجماعي ببعثٍ جديد. بالخروج من غرفة التحميض، لكأنَّك ترى نفسك أوَّل مرة. غادر الممثل تلك المنطقة الرمادية واكتسى ألوان الحياة. فجأةً، أنت تعيد اكتشاف نجومك؛ أي تعيد اكتشاف نفسك. ها أنت بالألوان! إلا أن دهشتك ليست دائمًا واضحة الأسباب. أنت لا تعرف لماذا أدهشك تِتر المسلسل الكويتي "الخرّاز" (2007م)، ربَّما بسبب قيام نبيل شعيل بغناء الكلمات التي وضعها مشعل مناور ولحّنها فهد الناصر. ولماذا أعجبك المسلسل العراقي "نادية" (1987م)، ربَّما بسبب اكتشافك ذلك الثنائي الذي ستكون له رفقة استثنائيّة: الشاعر كريم العراقي والفنان كاظم الساهر، في لحن جعفر الخفّاف. ولا نهاية للحظات الدهشة، ولا سيّما مع المسلسلات المصريّة، منها: مسلسل "رحلة السيّد أبو العلا البشري" (1985م)، بشعر سيد حجاب، وموسيقى عمار الشريعي، وغناء علي الحجّار؛ و"المال والبنون" (1993م)، بشعر سيد حجاب، وموسيقى ياسر عبدالرحمن، وغناء علي الحجّار؛ و"مسألة مبدأ" (2003م)، بشعر عبدالرحمن الأبنودي، وموسيقى عمر خيرت، وغناء علي الحجّار.
تحوُّلات كثيرة اتّخذت شكل تحديات
تحدّي "إثارة الانتباه"، الذي أصبح غاية في ذاته، بات يطرح أسئلة فنية حقيقية: كيف تجذب انتباه جمهور مُتخمٍ بالمغريات؟ كيف تحتكم إلى القيم في عصر تحكمه الخوارزميات؟ كيف يُمكن أن تتعمق في العمل الفني بعيدًا عن شروط محرّكات البحث، ومن دون أن تفقد فرصة الظهور في المراتب الأولى للمنصات الرقمية؟ بعبارة أخرى: كيف تنتج عملًا فنيًّا وتجاريًّا في الوقت نفسه؟ كيف تستطيع ألا تخسر روحك الفنيّة، إذا كنت مطالبًا بالانتشار والرواج وفرض نفسك على قنوات التواصل؟ والحقُّ أن هذا صعب، لكنه ليس مستحيلًا.
لدينا أكثر من صيغة لصناعة الحدث في هذا السياق. المسلسل السعودي "طاش ما طاش" (1993م) تكوَّن تِترُهُ من جملة وحيدة (على موسيقى لخالد العليان)، لكن خفَّة ظلِّ الممثلين وذكاء الدعابة والدرجة العالية من السخرية كانت كافية لصنع الحدث. والمسلسل التونسي "صيد الريم" (2008م)، اعتمد في التِتر على أغنية "فنيّة" لم تتنازل لمتطلبات الإبهار، وهو من كلمات حاتم القيزاني وموسيقى ربيع الزموري وغناء صابر الرباعي. والمسلسل المصري "ليالي الحلميّة" (1987م) نجح في العمل وفي التِتر بالدرجة نفسها. لقد استطاع لفت الانتباه شكلًا ومضمونًا. وربما بلغ نجاح التٍتر إلى درجة استقلاله عن العمل ذاته. لقد أتاحت الصور لكلمات سيد حجاب وصوت محمد الحلو ولحن ميشيل المصري، أجنحة سحريّة عبرت به الأجيال والأماكن والأزمنة، فإذا هو أغنية خالدة تجرّ معها الدراما: "منين بييجي الشجن، من اختلاف الزمن. ومنين بييجي الهوى، من ائتلاف الهوا...".

مسلسل ليالي الحلمية (1987-1995م)
هوية التِتر" وموقعه الفني من العمل
بدأ التِتر على هامش المتن الدرامي، حين كان الترويج معتمدًا على مراكمة الأسماء الجذّابة. وجه حسن وصوت جميل وجماهيري يضمنان حضورًا للعمل في انتظار أن يصنع جمهوره. ثمَّ حاول التِتر في بعض الأعمال الحديثة "محاذاةَ" الجوّ العام للأحداث. ثمَّ أصبح جزءًا من السرد نفسه، يحرّك عواطفنا من خلال الموسيقى واللون والإيقاع، فضلًا عن الكلمات؛ ليصبح بذلك أحد العناصر الأساسية التي تمدّ الجسور بين العمل الدرامي والجمهور.
التِتر اليوم كيان قائم بذاته، وفي الوقت نفسه داخل في كيان النص ككل، ولهُ أهمية العناوين والعتبات في القصص والروايات. إنه جزء من البناء، ولبنة فنية تُمهّد للدخول في عالم خيالي أو حقيقي تتداخل فيه الشخصيات مع الأحداث. رأينا ذلك في المسلسلين المغربيّين: "الماضي لا يموت"، حيث يضعك التِترُ ببنائه المحكم في تطابق تامّ بين رقعة الشطرنج وقطعه المتطايرة ورقعة الأحداث وقطعها المتصادمة على "رقعة" الواقع المتخيّل؛ ومسلسل "الزعيمة" الذي يتطرق إلى موضوع اقتحام المرأة عالم العمل السياسي، واعتمد التِترُ فيه على حضور المحمل الورقي، مثل الكتب وصفحات جرائد والمخطوطات، على الرغم من ندرة المشاهد التي نرى فيها الكتاب حاضرًا في الدراما العربية.
تحدِّي "نَسَب التِتر"
مَن الذي يملك حقَّ إطلاق الاسم؟ خاصة مع بروز دور "الكاستينغ" في جملة أدوار عديدة، وأحيانًا فنون عديدة، مستجدّة، وظهرت على حساب أخرى انقرضت أو تكاد. كان منتج العمل "أبا التِتر" وصاحب القول الفصل فيه. أحيانًا هو كاتب القصة والسيناريو والحوار، وأحيانًا هو المخرج. ثمَّ توزَّعَ نَسَبُ العمل بين آباء كثيرين. حدث الشيء نفسه في الموسيقى بظهور التوزيع والمكساج والفيديو. كما ظهر في الرواية الأدبية مع ظهور مهنة "المحرّر" الذي أصبح من حقه التدخل في جوانب كثيرة من العمل، قد تتجاوز العنوان وترتيب الفصول إلى حذف فقرات أو تطوير شخوص وأحداث في الرواية.
في المسلسل السوري "صلاح الدين الأيوبي" (2001م) مثلًا، الذي اعتمد في التِتر على قصيدة محمود درويش "عابرون في كلام عابر"، بموسيقى طاهر ماملّي وغناء أصالة نصري، لا مجال للتشكيك في مستوى القصيدة والصوت، وحتى اللحن. لكن "التوليفة"، على الأقل في نظر كاتب هذه السطور، لم تكن ناجحة. بدت المطربة بعيدة عن الموضوع، ولم تستطع صور الجينيريك الإمساك بالمتفرّج لإقناعه بصدقية علاقتها بزمن الأحداث. ثمَّة خطأ في الكاستينغ أنتج "فجوة" بين العمل والجمهور؛ إذ الأمر أشبه بأنَّك تدخل القدس مع صلاح الدين مرتديًا سموكينغ وفي يدك هاتف محمول. وهذا على العكس من الإحساس الذي أعطانا إياه المسلسل المصري "الخواجة عبد القادر" (2012م) الذي اعتمد في التِتر على شعر الحلَّاج، بموسيقى عمر خيرت وأداء جماعي. كاستينغ موفَّق غاية التوفيق.
والحقُّ أن الكاستينغ أصبح ذا شأن وأي شأن. وهذا الدور لا يقتصر على "اختيار الممثّلين"، بل يتخطّاه إلى اختيار "فريق التِتر". لِمَن نعهدُ بمسؤولية الكلمات والتلحين والأداء والتوزيع، ثمَّ لمن نعهد بمهمّة التصميم والتصوير والمونتاج.

مسلسل طاش ما طاش (1993-2023م)
تحدّي "صِدام الساعات"
تراجَع الزمن المشترك في أغلب المجتمعات. انفصلت الساعة المدرسية عن الساعة الأُسَرِية، والساعة الأُسَرِيّة عن الساعة المهنية، والساعة المهنية عن الساعة الاجتماعية، وانفصلت هذه الساعات كلّها عن الساعة الثقافية. فإذا نحن أمام حياة اجتماعية متشظية إلى ساعات متناحرة، تعمل كلُّ واحدة لحسابها وتدور عقاربها في الاتجاه المعاكس للأخرى، ولا تُنتج إلا غرباء يزدادون كلَّ يوم غربة، لا عن فضاءات العمل والتربية والثقافة فحسب، بل عن أنفسهم ومكانهم وزمانهم وواقعهم وخيالهم أيضًا. وأمام هذا الواقع، توهّم كثيرون أنهم قد يجدون في الدراما كنايةً عن تسمية فضاء مشترك، يُعيدهم إلى زمن جماعي منشود ومفقود، وقِيَم مطلوبة ضائعة. لكن ذلك ظلَّ بعيد المنال. تشظَّت الأسرة وتفتّتَ المجتمعُ إلى جُزُرٍ فردية في غياب مفهوم الفرد. دخلت المنصات الخاصة على الخط، وأصبحت تُنافس الفضائيات الكلاسيكية. فإذا كُلٌّ له تقسيمه الخاص للزمن. كُلٌّ يخصّص للفرجة الزمن الذي يناسبه. كُلٌّ له ذوقه واهتمامه. كلٌّ له برنامجه المفضّل والفضائية التي تعجبه والمنصة التي تروق له، بل كُلٌّ يحمل تلفزيونه في جيبه.
لكل متفرّج تِتر خاص!
هذا لا يعني أنها تغيَّرت إلى الأفضل، كما لا يعني أنها تغيَّرت إلى الأسوأ. أنت في مرحلة مختلفة، عليك أن تتعامل معها بأدوات مختلفة. عليك أن تحيّن برمجياتك، والأفضل أن تُسهم في ابتكار برمجياتك بنفسك. لا فائدة من النوستالجيا والتحسّر على زمن جميل هو في الحقيقة الزمن الحاضر، لكنّك آخر من يعلم. آن أوان مراجعة طقس "الفرجة الجماعية". تغيَّر مفهوم الفرجة اليوم، وتغيَّرت صِيَغُها. لم تعد الفرجة طقسًا جماعيًا، بل طريقة لإثبات الذات المتفرّدة المتحرّرة، المنشقّة عن القطيع. الفرجة اليوم على عدد المنصات والقنوات الشخصية. بل ربَّما بات لكلِّ مُشاهِد قناتُه الخاصة التي يحدّدها له "ذكاؤه الاصطناعي الشخصي" الخاصُّ به. وها أنتَ تشرع في مشاهدة مسلسلات يتدخّل المشاهد في اختيار نهاياتها، وفي تحريك أحداثها، وفي بناء سيناريوهاتها وفق ما يروق له، في علاقة بالألعاب، وقد يضع التِتر بنفسه.
هكذا نكون على عتبة تِترٍ لكل متفرّج.