
التربية الأبوية
على مرِّ العصور، كان تعليم الأبناء مهارات الحياة هاجسًا لدى الآباء، بدءًا من تعليمهم كيفية النجاة من الوحوش في العصر البدائي إلى مهارات العيش بين الناس في مجتمع، وإتقان عمل يعتاشون منه ويكتسبون به مكانتهم في المجتمع.
في أوائل القرن العشرين عرَّف عالم الاجتماع الفرنسي، إميل دوركايم، التربية بأنها التأثير الذي يجريه الجيل الراشد في الجيل الناشئ. والتربية ليست علاقة ثنائية بين الأهل من جهة والطفل من جهة؛ بل تـتدخل فيها عوامل المجتمع ومنظومته القيمية وسلوك أفراده الآخرين وأنواع الفن السائدة فيه والرفاق والأقارب، ثم تأتي المدرسة بمناهجها وأنواع الراشدين والأطفال فيها.
وما بين التشدّد في القسوة، سواء أكانت جسدية أم لفظية، التي يمكن أن تكون في ظروف معينة مسيئة أكثر مما هي ضابطة ومحسّنة، والتراخي الذي يترك الطفل والمراهق من دون حسيب أو رقيب وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك؛ هناك مساحة وسطى بالغة التعقيد، تحاول “القافلة” أن تستطلعها هنا من خلال ثلاث مشاركات. ففي البداية، يستعرض أسامة أمين، الممارسة التربوية التي كانت حتى الأمس القريب الأكثر شيوعًا في العالم: الضرب.. ما له وما عليه. وفي المشاركة الثانية تتعرض نعيمة بنعبدالعالي لماهية المنطقة الوسطى التي أشرنا إليها آنفًا، من خلال ما توصَّل إليه المربّون وعلماء النفس والاجتماع في العصر الحديث. ومن ثَمَّ، يُسلِّط د. سعيد هادي وهاس الضوء على جذور قضية التربية التي تمتد عميقًا إلى لحظة زواج الأبوين، وربَّما إلى ما قبلها؛ لضمان أهليتهما لتربية الأبناء المرتقبين.
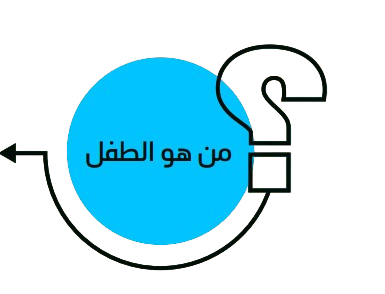
يُطلق توصيف “الطفل” في القوانين والأعراف التربوية والعقابية على المولود حتى يبلغ سن الرشد، التي تدور حول الثمانية عشر عامًا، تزيد أو تنقص عامًا أو عامين بحسب التشريع في كل بلد من البلدان.
وقد بدأت الجهود الدولية الجماعية لحماية الطفل بإعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924م، ثم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959م الخاص بالطفل، والمعترف به ضمن مدوّنة حقوق الإنسان الدولية. وتطوَّرت القوانين الوطنية لرعاية الطفل إلى حدٍّ قد يراه الشرقيون تطرفًا في القوانين الغربية التي تصل إلى حد نزع الأطفال من أسرهم لحمايتهم من الضرب. فتقوم الدولة بدور الأب للآباء، وهذا محل نزاعات قضائية بين المهاجرين والحكومات، خصوصًا ذات الرعاية القصوى للأطفال مثل السويد.
الضرب في ذاكرة الأدباء
على عكس الغالبية العظمى من الذين تعرضوا للضرب في طفولتهم على أيدي والديهم، ونسوا أو تناسوا ذلك بمرِّ السنين، فإن بعض الأدباء قرَّروا أن ينشروا ذلك على الملأ؛ ليقرأه آلاف الأشخاص. وليس بوسعنا أن نحدد هل كان ذلك بدافع الانتقام من آباء وأمهات تلك الحقبة من الزمن، أم لتعريف الناس بتأثير ذلك الضرب على نفسية الطفل.
اكتسبت رواية محمد شكري “الخبز الحافي” شهرتها العالمية من أنها تُقدِّم نموذجًا للحياة العارية أو “الهومو ساكر”؛ إذ يكون الإنسان مجرد مخلوق مجرد من حقوقه، ليس لديه سوى حياته البيولوجية. ففي قلب منظومة الفقر التي تعالجها الرواية، أب غضوب جامح، ومن أفظع مشاهدها وصف البطل لضرب شقيقه الأصغر الذي أفضى إلى موته.
هذا استثناء فظٌّ، تقابله عشرات الشهادات من مفكرين وأدباء في مذكراتهم حول صعوبات طفولاتهم التي اكتنفتها ألوان مختلفة من العقاب. ربَّما لا يذكرون الضرب فيها صراحة، لكن آثاره تظهر في الخوف الشديد من رب الأسرة، وهذا ما يشير إليه عميد الأدب العربي طه حسين بمواربة لطيفة في سيرة حياته “الأيام”. إذ يصف سكونه وإخوته عند استيقاظ الأب، ويستمر ذلك الهدوء حتى يتوضأ ويصلي ويقرأ ورده ويمضي إلى عمله: “فإذا أغلق الباب من دونه، نهضت الجماعة كلها من الفراش، وانسابت في البيت صائحة لاعبة، حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية”.
وتناول نجيب محفوظ هذا الأمر في أكثر من موضع في ثلاثيته الشهيرة، “بين القصرين – قصر الشوق – السكرية”. فكان أحمد عبدالجواد، ذلك الأب الصارم الذي يمتلك الصلاحيات المطلقة، يضرب الأبناء بيده الثقيلة. وحين يبكون، كانوا يخفضون رؤوسهم، ولا يتجرؤون على رفع أعينهم في وجهه؛ لأن ذلك يعدُّ تحديًا لا يُغفر. وهذا ما خلق جدارًا من الخوف بينه وبين أولاده.
وفي ألمانيا، وصف كاتب اسمه “أولريش لاند” أحد هذه المواقف على النحو الآتي: “وقفت والدتنا أمامنا، وأشارت إلينا مرة أخرى بإصبعها الممدود ألا نحرك أيدينا الممتدة إلى أسفل. كانت أي حركة لا إرادية لرفع اليدين لحماية الوجه ستؤدي إلى صفعتين إضافيتين. كان هذا جزءًا من القواعد غير المكتوبة لهذا الطقس. ثم انهالت على كل واحد منا بسلسلة من عشر صفعات متتالية”.

هل كان الأهل أشرارًا؟
أسامة أمين
يتذكر كبار السن جيدًا تجاربهم مع الضرب الذي تلقوه على أيدي الوالدين ومن المعلمين، بل ربّما من بعض الأقارب. فالكل كان يرى أن من حقه أن يُسهم في عملية التربية. ولعلَّ ما يواسي هؤلاء أن يعلموا أن هذا النمط من التربية لم يكن مقصورًا عليهم، بل كان منتشرًا على مستوى العالم في الماضي.
وحتى اليوم، وفي الدول الرائدة في علم النفس وإطلاق النظريات في التربية الحديثة، لا يزال الضرب مسموحًا في بعضها، كما هو الحال، على سبيل المثال، في 17 ولاية أمريكية. ولا يزال عدد من خبراء التربية والمفكرين يكافح لإنهاء هذه العادة، ومن بينهم طبيبة الأطفال والأستاذة المساعدة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، جايمي أندرسن، التي تؤكد أن الضرب لم يزل يُمارس حتى في الولايات التي تمنعه، ولو على نطاق ضيق لا يجري الإبلاغ عنه دائمًا. كما أن الدول التي تمنعه، تعترف بأنه ما زال مستمرًا، لكن بعيدًا عن الأعين.
تناقضات الصورة في ذهن الطفل
من المبالغات الظالمة أن يصوِّر البعض طفولتهم وكأنها كانت عبارة عن سنوات من التعذيب المتواصل. بل على العكس من ذلك؛ إذ لا بدَّ للذاكرة من أن تستعيد لحظات كثيرة كانت مليئة بالحب والحنان، ومواقف لا حصر لها كان الآباء والأمهات فيها يلاعبون أطفالهم ويضحكون معهم.
لكن يبدو أن هذه اللحظات والمواقف الإيجابية، هي التي كانت تجعل كثيرًا من الأطفال، آنذاك، يتساءلون هل كان من يعنّفهم ويضربهم بقسوة في هذه الليلة، هو الشخص نفسه الذي كان يحنو عليهم ويلاطفهم في الليلة السـابقة. وكان ذلك يسبب لهم الحيرة والتوتر المستمر؛ لأنهم لا يستطيعون توقُّع أي الشخصيتين سيكون موجودًا في الليلة التالية.
بعض الآباء والأمهات تنتابهم نوبة من الندم على فعلتهم، حين يرون فلذات قلوبهم ينظرون إليهم بخوف وريبة، حتى إذا أرادوا أن يُربِّتوا عليهم، فزع الأطفال ونفروا منهم، فيسعى الآباء والأمهات لتبرير العنف الذي ارتكبوه بعبارات تزيد من ألم الطفل بدلًا من أن تخفف عنه، من قبيل: “إنما نفعل ذلك من أجل مصلحتك”، أو “إنما نضربك لأننا نحبك، ونريدك أن تصبح أحسن الناس”. ولكن عقل الطفل لا يستوعب هذا المنطق المتناقض.
وهنا، لا بدَّ من الإشارة إلى أن البعض الآخر من الآباء والأمهات كانت تعتريهم نوبات متزايدة من الغضب، حين يدركون فشل محاولاتهم في تهدئة الطفل، فيلجؤون إلى أسوأ الممارسات على الإطلاق، وهي استئناف الضرب عقابًا على البـكاء والصراخ، فكأنهم يرون أن عدم التوقف عن البكاء هو نوع من التحدي لهم.
لماذا الضرب؟
لأن هذا ما كان يفعله الجميع
من المؤكد أن الغالبية العظمى من الأهل، الذين كانوا يمارسون الضرب بوصفه أسلوب تربية، لم يكونوا يستمتعون بذلك، بل كانوا يفعلون ذلك لأسباب عديدة، على رأسها الاعتقاد السائد، آنذاك، بأن هذه الطريقة ناجحة وتُؤتي ثمارها بأسرع وقت. فالطفل الذي يتلقى صفعة على وجهه، أو ضربات متوالية بالعصا على جسده؛ لأنه لعب في الشارع بعد المدرسة، بدلًا من العودة مباشرة إلى المنزل، للقيام بالواجبات المدرسية؛ سيفكر في المرة القادمة ألف مرة، قبل أن يطيع أصحابه باللعب معهم.
هذا ما تعلمه الوالدان من قبل على أيدي والديهما، وتوارثا هذا الأسلوب من التفكير. ولم يكن من المعتاد أن يفكر الناس في الآثار السلبية للضرب، الذي لا يجعل الطفل يقتنع، بل يكسر إرادته، ويزرع الخوف داخله، ويقلل ثقته بنفسه؛ بل ربَّما يؤدي هذا الضرب إلى ترسيخ قناعة لدى الطفل أنه إنسان سيئ يستحق هذا العقاب؛ لأنه هو المسؤول عن تحوّل أبيه وأمه عن الشخصية الطيبة اللطيفة، إلى هذين الشخصين اللذين يشعر بالقشعريرة منهما في هذه اللحظات.
لا يزال الضرب مسموحًا حتى في بعض الدول الرائدة في علم النفس وإطلاق النظريات التربوية الحديثة، ولا يزال الخبراء والمفكرون يكافحون لإنهاء هذه العادة.

كانت هذه هي الثقافة السائدة في المجتمع، والكل يكرر عبارات من قبيل “العصا لمن عصى”، وما كان يقال للمعلمين من نوعية “لكم اللحم ولنا العظم”. ولم يكن هناك من يعترض على هذا النهج من التربية، كأن يطالب أحد ما الأب أو الأم بالتوقف عن ذلك؛ لأنه كانت هناك قناعة بأن الطفل ملك لوالديه، يفعلان به ما يرونه في صالحه.
لم تكن الدراسات التي تناولت التأثيرات النفسية على الطفل الذي يتعرض للعنف، قد شقَّت طريقها إلى الرأي العام بعدُ. ربَّما نشرت بعض الصحف مقالات، وربَّما سعت برامج تلفزيونية لتوضيح ذلك، لكن الغالبية العظمى لم تكن تحب أن تطلع على ما يخالف قناعاتها وموروثها الذي تلقته من الجيل السابق، فضلًا عن أن المكانة والسلطة التي كان الوالدان يتمتعان بها، لم تكن تقبل الانتقاص منها.
إذًا، ليست الرغبة في الانتقام محرك هذا العنف من الوالدين على الأطفال، بل قلة المعرفة بوجود وسائل تربية بديلة أفضل من الضرب، وكان التركيز على الهدف، مع عدم مراعاة عواقب الوسيلة المستخدمة. وكانت هناك رغبة في السير مع المجتمع في الطريق الذي تسلكه الغالبية، إضافة إلى ضغوط الحياة الهائلة، آنذاك، والفهم الخطأ لمعنى احترام الوالدين.
هل الطفل نصف إنسان؟
لعلَّه آن الأوان أن يدرك الجميع أن الطفل ليس أحد ممتلكاتنا، بل هو إنسان يتمتع بالكرامة، كاملة غير منقوصة، من دون أن يقلل ذلك من مسؤولية الوالدين، وحقوقهما الأصيلة في تربيته. بل من المؤكد أن الوالدين هم أكثر الناس حرصًا على كرامة طفلهما وإنسانيته، والرغبة الأكيدة في تحقيق الأفضل له، على الأقل بحسب فهمهما لما هو أفضل للطفل، وهو ما قد يتسبب أحيانًا في الخلط بين ما هو الأفضل له، وما هو الأفضل لهما.
وإذا كانت الغالبية العظمى من دول العالم قد وقَّعت على اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2 سبتمبر 1990م، فإنه ليس من المتوقع أن يكون كل الراغبين في الزواج قد سمعوا عنها، وسعوا إلى الاستفادة من محتواها، الذي يشير، مثلًا، إلى أنه يجب على الحكومات حماية الأطفال من العنف والإساءة على أيدي المسؤولين عن رعايتهم، وأنه ينبغي للبالغين الاستماع إلى الأطفال والتعامل بجدية مع آرائهم.
والحل؟! قبل التفكير في معاقبة الطفل، وقبل الإبداع في أساليب العقاب، مثل حرمانه من مصروف الجيب، أو إلغاء السفر إلى الخارج في العطلة الصيفية، يجب البدء بترسيخ القيم، بالتعريف بما هو صواب وما هو خطأ، وشرح المبررات والأسباب، والاستماع إلى رأي الطفل، بما في ذلك أكثر الآراء استفزازًا؛ لأن ذلك يعطي الأبوين الفرصة للرد عليها، وهذا ما يعني ضمنًا أنه وثق بهما، وأطلعهما على ما يفكر فيه، بدلًا من أن يناقش أموره مع صديقه، الذي غالبًا ما سيؤيده، بدافع الصداقة، أو لأنه لا يملك المعارف اللازمة.

الضرب لا يجعل الطفل يقتنع، بل يكسر إرادته، ويزرع الخوف داخله، ويقلل ثقته بنفسه، ولربَّما أدى إلى ترسيخ قناعته بأنه إنسان سيئ وسيبقى كذلك.
الخطأ الذي يقع فيه الطفل ليس المشكلة، بل كيفية التعامل مع هذا الخطأ، مثل أن يسأل الأب نفسه أولًا، هل كان قد أوضح من قبل لابنه أن هذا السلوك خطأ؟ وهل كان هو وزوجته حريصين على أن يكونا مثلًا أعلى وقدوة في هذا السلوك؟ ثم يسأل عن الدوافع التي جعلت طفله يرتكب هذا الخطأ، ليس بهدف إيجاد المبرر له، بل لفهم الخلفية، وهو ما يساعد على التعامل مع الخطأ، وتربية الأطفال من دون اللجوء إلى العنف.
لا يمكن للضرب أن يكون الحل السحري لكل المشكلات، بل هو في المقام الأول دليل على عجز الوالدين عن توضيح الخطأ، من خلال لغة التواصل الطبيعية بين البشر، وهي الكلام. والضرب هو أفضل وسيلة لكسر إرادة الطفل، وجعله سهل الانقياد. ولكن هذا الانقياد لن ينتهي عند حدود باب البيت، بل سيلازمه في الخارج، فيطيع رفيق السوء، ولا يقدر على رد الظلم الذي يقع عليه من الآخرين، وربَّما يظل على هذه الوتيرة في الكبر ليكون إمعة في محيطه. فهل هناك من يريد ذلك لابنه أو ابنته؟

خطأ الطفل فرصـة للتعـلُّم
د. نعيمة بنعبدالعالي
يواجه الآباء والمربون تحديات يومية تتعلق ببعض السلوكيات غير المرغوبة عند الأطفال، مثل: الكذب، أو السرقة البسيطة، أو التمرد على السلطة الأبوية، أو إهمال المسؤوليات. هذه الأخطاء الأخلاقية ليست مجرد سلوكيات سطحية، بل هي تعبير عن قضايا أعمق مرتبطة بالنمو النفسي والاجتماعي للطفل.
هذه القضية ليست حديثة العهد، فقد تناولها الأدب والفلسفة والأنثروبولوجيا والعلوم التربوية على مر العصور؛ إذ جرى استكشاف تأثير هذه الأخطاء الأخلاقية، وأفضل الطرق لمعالجتها. ومن خلال استعراض أمثلة من الأدب، واستنادًا إلى التحليلات الحديثة، يمكننا الوصول إلى فهم أعمق لكيفية التعامل مع هذه السلوكيات بشكل فعَّال.
الأخطاء الأخلاقية بين الأدب والحياة
الأطفال ليسوا بالغين صغارًا، بل هم كائنات في طور التكوين النفسي والاجتماعي. فالكذب، على سبيل المثال، قد يظهر عند الأطفال في سن مبكرة بوصفه وسيلة لاستكشاف حدود الإدراك الاجتماعي. وتشير الدراسات النفسية إلى أن الأطفال، في سن الرابعة أو الخامسة، يبدؤون في تطوير ما يُعرف بـ “نظرية العقل”، حيث يدركون أن للآخرين معتقدات ورغبات قد تختلف عن واقعهم الشخصي. هذا الإدراك الجديد يدفعهم أحيانًا إلى اختبار هذه الفروق من خلال الكذب.
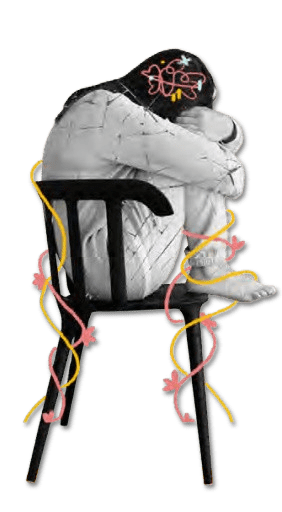
السرقة الطفولية هي ظاهرة أخرى ترتبط بمرحلة النمو؛ إذ ربَّما لا يفهم الطفل تمامًا مفهوم الملكية، أو يشعر برغبة قوية في امتلاك شيء من دون إدراك لعواقب أفعاله. هنا يجب أن يتعامل المربون مع هذا السلوك بوصفه فرصة للتعليم بدلًا من العقاب القاسي؛ لأن العقاب وحدَه قد يعزِّز شعور الطفل بالعار، أو قد يعزله نفسيًا.
أمَّا التمرد، فهو سمة شائعة في مرحلة المراهقة، حيث يبدأ الطفل في البحث عن هويته المستقلة. التمرد في هذه المرحلة هو تعبير عن الحاجة إلى إثبات الذات، ولكنه قد يكون أيضًا صرخة طلبًا للمساعدة، أو تعبيرًا عن ضغوط عاطفية غير مفهومة.
لطالما شكَّلت هذه الأخطاء الأخلاقية محاور مركزية في كثير من الأعمال الأدبية، وهو ما جعلها مرآة تعكس التعقيدات النفسية والاجتماعية للبشر. فلو أخذنا، مثلًا، رواية “بينوكيو”، التي جسَّدت الكذب بشكل رمزي عندما كان أنف الدمية يطول مع كل كذبة. الكذب هنا لم يكن مجرد خطأ بسيط، بل كان انعكاسًا لانعدام النضج وحاجة الطفل إلى التوجيه. لكن الحل لم يكن العقاب الصارم، بل توجيه الجنية الزرقاء لبينوكيو نحو تصحيح مساره، وهو ما يُظهر أهمية الحب والصبر في التربية.
من جهة أخرى، تُظهر قصص “جحا “العربية كيف يمكن للكذب أن يصبح وسيلة للتعامل مع الواقع الاجتماعي الضاغط. ففي إحدى النوادر، يدَّعي جحا أن أسدًا سرق كيس دقيقه ليتجنب الإجابة عن سؤال محرج. قد يبدو هذا التصرف ساخرًا، ولكنه يعكس قضايا أعمق مثل الضغوط المجتمعية التي تدفع الأفراد إلى اختلاق أعذار لتجنب المواجهة.
وفي الأدب الفرنسي، تُسلِّط رواية” الأمير الصغير” الضوء على قدرة الأطفال على التمرد ببراءة عندما لا يفهمون معايير عالم الكبار، وهو ما يجعل هذا التمرد جزءًا من اكتشاف الذات. على النقيض، تصوِّر رواية “1984” لجورج أورويل، كيف يدفع القمع المفرط الأفراد إلى الكذب والخداع بوصفه رد فعل على الرقابة الصارمة. الأدب هنا يُقدِّم رؤى متعددة الأبعاد؛ فهو لا يرى الأخطاء الأخلاقية بوصفها عائقًا فقط، بل إنها نقطة انطلاق لفهم أعمق للسلوك الإنساني.
الخوف الناتج عن العقاب يُحفّز “الدماغ العاطفي”، ويعوق عمل “الدماغ المُفكِّر”، وعندما يشعر الطفل بالأمان، يكون دماغه أقدر على الاستيعاب والتعلُّم من الأخطاء.
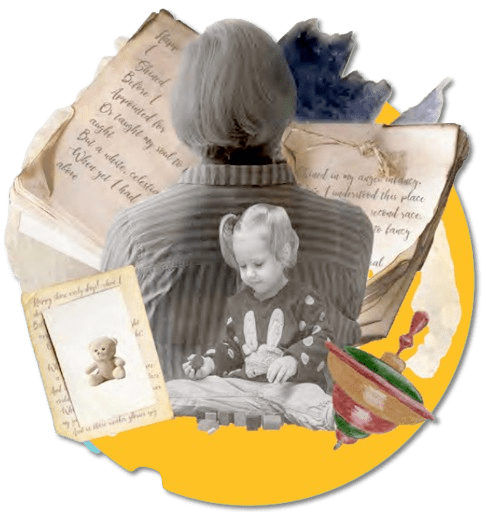
بين العقاب والتوجيه: أيهما أنجع؟
تُظهر البحوث التربوية الحديثة أن العقاب الصارم، خاصة إذا كان يتسم بالقسوة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وقد سبق لابن خلدون أن أشار إلى خطورة العقاب القاسي، حيث حذَّر من أنه قد يدفع الأطفال إلى الكذب خوفًا من العقاب، وهو ما يُظهر أن فهم الطفل لسلوكه يكون مشوهًا تحت ضغط الخوف.
على النقيض من ذلك، تشير النظريات التربوية الحديثة إلى أهمية الحوار والتفاهم بوصفهما وسائل فعالة لتوجيه الطفل. عندما يجري إشراك الطفل في مناقشة حول خطئه، يُعلَّم التفكير في عواقب أفعاله، وفهم أبعادها الأخلاقية. فيُعزز هذا النهج من قدرته على تحمل المسؤولية بشكل مستقل.
وتُظهر التجارب الحديثة في علم الأعصاب أن الخوف الناتج عن العقاب يُحفِّز “الدماغ العاطفي” (الجهاز الحوفي)، ويعوق عمل “الدماغ المُفكِّر” (القشرة المخية). فعندما يشعر الطفل بالأمان والثقة، يكون دماغه أقدر على استيعاب القيم والتعلُّم من الأخطاء.
لذلك، فإن التربية الحديثة توصي بتركيز الجهود على بناء حوار مفتوح مع الطفل، وهو ما يعزِّز الثقة المتبادلة مع أبويه، ويساعده على مواجهة أخطائه بشجاعة.
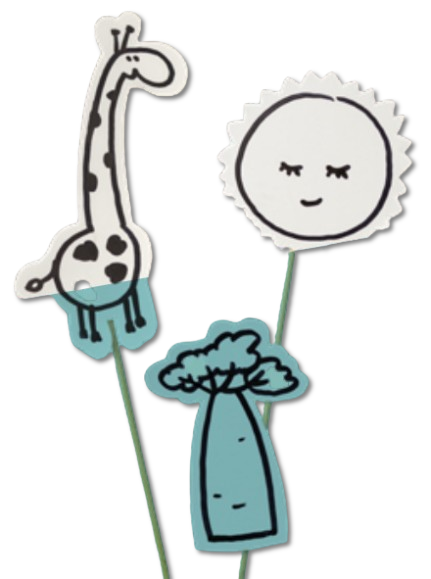
فهم الأسباب الكامنة وراء الأخطاء
إن أخطاءنا الصغيرة التي نرتكبها في صغرنا قد تكون أحيانًا مظاهر لحاجات نفسية عميقة. فعلى سبيل المثال، قد يلجأ الطفل إلى الكذب لتجنُّب الإحراج أو العقاب، أو وسيلةً لنيل قسط من الاهتمام. في المقابل، قد يكون التمرد انعكاسًا لرغبة الطفل في تأكيد هويته أو تحدي السلطة لتحقيق الاستقلالية.
تشير الباحثة الأنثروبولوجية، مارغريت ميد، إلى أن هذه السلوكيات قد تُفهم بشكل مختلف بحسب الثقافة. ففي بعض المجتمعات، يُنظر إلى الكذب بوصفه جزءًا من تطور الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال، بينما تعدُّه مجتمعات أخرى مؤشرًا على انهيار أخلاقي.
وتُقدِّم دراسات، مثل تلك التي أجرتها كارول دويك حول “عقلية النمو”، أدلة على أن الأطفال الذين يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء وتعلُّم الدروس منها يصبحون أكثر مرونة وإبداعًا في المستقبل. وتتماشى هذه الرؤية مع الأفكار التي وردت في قصص جحا، حيث تُقدَّم الأخطاء بلمسة فكاهية تجعلها فرصة للتأمل والتعلم.
التربية في عصر التحديات المعاصرة
مع تقدُّم العلوم التربوية والمعرفية، أصبحت التربية اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فالتكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتغيرات الثقافية السريعة، تضيف تحديات جديدة أمام المربين. ولم تعد الأخطاء الأخلاقية مقتصرة على الكذب أو التمرد، بل تشمل قضايا مثل: التنمر الإلكتروني، والغش الأكاديمي، وغيرهما.
تتطلب هذه التحديات نهجًا متكاملًا يجمع بين الفهم العميق للنفسية البشرية والاستفادة من الموارد المتاحة مثل: الأدب والفنون والعلوم الحديثة. فالأخطاء الأخلاقية لدى الأطفال ليست مجرد تحديات يجب التغلب عليها، بل هي خطوات في رحلة طويلة نحو النضج. وتتطلب التربية الفعّالة توازنًا بين الحزم والتسامح، وبين العقاب والتشجيع.
وعندما نفهم أن كل خطأ يمثِّل فرصة تعليمٍ قيمة، نصبح قادرين على مساعدة الأطفال على بناء شخصيات قوية ومستقلة.
إن التربية ليست مجرد عملية نقل للمعرفة، بل إنها بناء مستمر للقيم الإنسانية. ومن خلال الدمج بين الأدب والعلوم والخبرة الحياتية، يمكننا بناء نهج تربوي شامل يساعد الأطفال على تجاوز أخطائهم، ليس فقط لتصحيح السلوك، بل أيضًا لإثراء شخصياتهم.
عندما يخطئ الطفل، فإن استجابتنا بوصفنا مربين هي ما يحدد ما إذا كان الخطأ سيصبح تجربة تعليمية أم نقطة ضعف مستدامة. وبالحوار والتفهُّم والحب، يمكننا تحويل كل خطأ إلى لبنة في بناء شخصية الطفل.
التربية والتعليم.. نحو نهج شامل
التربية ليست مجرد تصحيح أخطاء، بل هي عملية مستمرة تهدف إلى بناء شخصية الطفل على أسس أخلاقية قوية. وهذا لا يعني أنه يجب غض الطرف عن الأخطاء، ولكن يجب التعامل معها بحكمة تراعي احتياجات الطفل ودوافعه.
تشير الأبحاث الحديثة إلى أهمية التوازن بين الثواب والعقاب. فعلى سبيل المثال، تُعدُّ مكافأة السلوك الإيجابي بشكل مدروس من الأدوات الفعّالة لتعزيز القيم الإيجابية. وفي الوقت نفسه، يُفضَّل أن يكون العقاب إصلاحيًا وليس انتقاميًا. العقاب الإصلاحي يهدف إلى تعليم الطفل عواقب أفعاله بطريقة تجعله يكتسب فهمًا أعمق للمسؤولية.
ويمكننا أن نعدد من أسس التربية الحديثة والفاعلة أهمها، وهي:
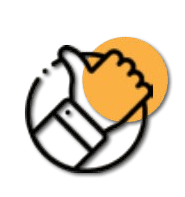
١- التعلم من الأخطاء.. منظور إيجابي
عندما نُعيد النظر في الأخطاء الأخلاقية من منظور إيجابي، نجد أنها تمثل فرصًا للتعلُّم والنمو. ولهذه الغاية يمكن، على سبيل المثال، استخدام القصص الأدبية أداةً تعليمية لمساعدة الأطفال على استيعاب القيم الأخلاقية؛ لتوضيح عواقب السلوكيات السلبية بطريقة غير مباشرة.
٢- دور المجتمع في تشكيل الأخلاق
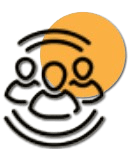
تؤدي الثقافة دورًا حاسمًا في تحديد الكيفية التي يرى بها المجتمع الأخطاء الأخلاقية ويتعامل معها. في المجتمعات التي تفرض معايير صارمة وتوقعات مثالية، قد يجد الأطفال أنفسهم تحت ضغط هائل يلجؤون معه إلى الكذب أو التمويه تجنبًا للعقاب أو تحقيقًا للتوقعات.
وعلى الجانب الآخر، المجتمعات التي تشجع على حرية التعبير والتعلُّم من الأخطاء، توفر بيئة أكثر دعمًا لنمو الطفل. وهنا يظهر مفهوم “الخطأ كفرصة”، حيث يجري التركيز على تعليم الطفل كيفية تجاوز الخطأ وفهم عواقبه بدلًا من تجنُّب العقاب.
تشير أبحاث كارول دويك، على سبيل المثال، إلى أهمية تعزيز “عقلية النمو” لدى الأطفال، حيث يتعلمون أن الفشل ليس نهاية المطاف، بل هو فرصة للتعلُّم والتطور.

رخصة تربية قبل الإنجاب!
د. سعيد هادي وهاس
عند بداية التفكير في الارتباط الزوجي ما بين الرجل والمرأة، هناك سؤال جوهري يُفترض طرحه: هل الاثنان صالحان ومؤهلان لتنشئة ذرية؟ وهل من الواجب امتلاك رخصة “تربية أبناء” وفقًا لمعايير الكفاءات التربوية ومخرجاتها من جهات مرجعية للتربية السليمة والصحية من جهة أخرى؟
ليس كل من يدخل قفص الزوجية صالحًا لتربية أبناء. وهناك كفاءات تربوية لا بدَّ من توافرها في الأب والأم. فمن يودُّ أن يصبح طبيبًا أو مهندسًا أو معلمًا… إلخ، فلا بدَّ له من امتلاك الكفاءات المهنية لكل مهنة من هذه المهن من خلال اكتساب المعرفة العلمية بداية، وترجمة تلك المعرفة العلمية إلى مهارات مهنية. كذلك هو واقع التربية كي نخلق ثروة بشرية ورأس مال إنساني يفيد نفسه بداية، ومن قام على تربيته ومجتمعه وأمته وجميع البشرية. لأن منجزات اليوم في شتى جوانب الحياة، هي وليدة فكر بشري فردي وجماعي، وبذلك تصبح المنجزات الفردية ملكًا للجميع، وتعطي ثمارها في مختلف بقاع الأرض. في المقابل، فإن الجريمة بشتى أشكالها وصورها والتدمير والضياع والمخدرات وجميع صور المعاناة ذات العلاقة وضعف الأمم والشعوب وانعدام رأس المال البشري، ليست إلا مخرجات لانعدام الكفاءات التربوية عند الآباء والأمهات. لذا، قيل إن التربية “علم”؛ لأنها قائمة على معطيات معرفية ونظريات علمية تُكتسب من خلال القنوات الأكاديمية الرسمية، وفي الوقت نفسه هي “فن” يُنال من خلال التدريب والإشراف، ليُقال إن هذين الأبوين صالحان لتربية الأبناء.
التخبط بين الأساليب المتعددة
تتعدد الأساليب التربوية ما بين المُفرط في الشدّة، وتتمثل في التسلُّط والغلظة والإهمال والعنف الجسدي والعاطفي والحرمان من جهة؛ واللين والمرونة الزائدة والدلال المبالغ فيه والخوف والحماية المفرطة، من جهة أخرى، وهناك مسار الـ”بين بين”. إذ لا توجد هناك حدود قاطعة بين القطبين. ولكن في نهاية المطاف، تتساوى المخرجات الكارثية لتزيد في العقاب أو التدليل. والعجيب أن من يمارسون ذلك لا يدركون أنهم وأبناءهم في المنطقة المحظورة نتيجة الجهل وامتلاكهم لمعتقدات خاطئة وإرث تربوي. فمنهم من يقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا وسوف نسير على نفس الخطى والنهج. ومنهم من يتبنى نهجًا تربويًا خاصًا من خلال المحاولة والخطأ. لكن الوقت حاسم ولا يحتمل هذه السياسة التربوية الخاطئة الناجمة عن التخبط التربوي، الذي يُفضي إلى مخرجات عقيمة وآثار مدمرة ونتاج فاسد على جميع الصُّعُد.
الأساس في شخصيتي الأبوين
إن معرفة النمط التربوي السليم ضرورية. وهذا النمط ليس وليد لحظة أو ساعة أو يوم، وإنما نهج ممتد منذ اختيار الزوج والزوجة، وخصائصهما السلوكية، وسماتهما الشخصية، ودرجة النضج لدى كل منهما، ومستوى التوافق بينهما، ومهارات التعايش الزوجي والأسري، وحل الخلافات بينهما؛ وذلك منذ بداية فترة الحمل إلى ولادة الطفل ومراهقته بمراحلها المتعددة، وصولًا إلى مرحلة النضج. ومثل هذا لن يأتي بالمصادفة المحضة، ولا يُباع في الأسواق، ولا يُهدى ولا يُورّث، وإنما هو مسيرة ورحلة زمنية تمتد إلى عقود تُكتسب من خلال كفاءات تربوية تؤخذ من مصادرها العلمية ومهاراتها.

يأتي الثنائي، الرجل والمرأة، إلى ساحة الزواج بخصائص وخلفيات متباينة على كل الصُّعُد. ويمكن لهذا التباين أن يشكِّل تربة خصبة لنشأة جيل مضطرب. فالأمر يحتاج إلى مستوى إدراك لدى كل من الزوج والزوجة لطبيعة الارتباط الزوجي الذي يؤثر في الأبناء. ومن ثَمَّ، لا بدَّ من تلاقي الثنائي، الرجل والمرأة، في منتصف الطريق “المنطقة الآمنة” بين قطبيهما.
يُضاف إلى ما ذُكر من الأساليب التربوية المتبعة من قبل الوالدين والمحيطين، عوامل أخرى لا تقل أهمية عن أنماط التربية التي تلقي بقاتم ظلالها على حياة الأبناء، تتمثَّل في الصراعات والخلافات المستمرة وغير المحلولة بين الزوجين والأسرة عمومًا، وأثر ذلك على مسار الأبناء. كما أن أحد الوالدين قد يعاني أزمات صحية أو نفسية أو سلوكيات مرضية، وما يخلفه مثل ذلك على سير التربية. يُضاف إلى ذلك كله، “الأسر الفوضوية”، وغياب الحدود العائلية، ومعرفة دور كل عضو في الأسرة. ولذا، يُقال إن التربية ليست نتاج الأبوين فقط، على الرغم من أنهما نواة الأسرة. غير أن دور الأسرة الممتدة والمجتمع المحلي والعام لا يقل أهمية عن دور الأسرة النواة.
ولعلَّ ما يجب الإشارة إليه هنا نظرًا لأهميته البالغة، هو العنف الأبوي والأسري تجاه الأبناء من قبل الوالدين والمقربين، سواء أكان العنف جسديًا أم لفظيًا أم عاطفيًا. ويأتي العنف إمَّا نتيجة الجهل بأساليب التربية، وإمَّا لعقد نفسية أبوية سابقة وتراكمات نفسية خفية شعورية ولا شعورية تحرك الآباء والأمهات صوب هذا المسلك الخطير والمنزلق الصعب. يسلك الطفل في غالب الأحيان سلوكًا قد يبدو غير مُرضٍ لتوجهات الآباء والأمهات وفقًا لقواعد وقراءات فكرية ومعتقدات تكوَّنت لديهم خلال مسيرة حياتهم لا يعيها الطفل، وعند مخالفته لمثل هذه المنظومات الخارجة عن إدراكه يُعاقب، وقد يصل العقاب إلى العنف وسوء المعاملة غير المبرر.

الأخطاء الأخلاقية تمثِّل فرصًا للتعلُّم والنمو. ويمكن الاستعانة بالقصص الأدبية أداةً تعليمية لمساعدة الأطفال على استيعاب القيم الأخلاقية.
التعزيز أهم من العقاب
ما نودُّ تأكيده هو أن العقاب بوصفه إجراء سلوكيًا لا يُوصى به من قبل أهل الاختصاص؛ لأنه يقود لما هو أسوأ منه، ويتعارض مع حقوق الطفل، ومخرجاته عادة سيئة. والبديل السلوكي المناسب للعقاب والمُوصى به هو ما يُعرف بـ “التعزيز” بشقيه: التعزيز الإيجابي، والمتمثل في مكافأة الطفل عندما يصدر عنه سلوك مرغوب وحسن من خلال المعززات التي يرغب فيها بهدف استدامة ذلك السلوك الصحيح؛ والتعزيز السلبي، والمتمثِّل في سحب شيء يرغب فيه الطفـل، عند ظهور سلوك غير محبب مع الشرح الوافي للطفل لماذا أُعطِي المعزِّز الإيجابي، وكذلك المعزِّز السلبي.
أجمعت الدراسات والأبحاث على أن الخبرات السابقة السيئة، ويتربع على قمتها النمط الوالدي في التربية، هي السبب الرئيس وراء ظهور الاضطرابات النفسية، بدءًا من البسيطة وصولًا إلى المُعقَّدة، مثل: الإدمان والعنف والإرهاب والالتصاق المرضي، ويمتد الأمر ليشمل بنية الدماغ ووظائفه. إذ إن مثل تلك الخبرات السابقة السيئة تشكِّل مفهومًا هشًا للذات، وتبني قاعدة لمعتقدات مشوهة، وتقود إلى سلوك التعلُّق وضعف الكفاءة الذاتية و “الأنا العليا” (Super Ego) الخالية من قيم الحياة، وعقد نقص، ونقص في مهارات التواصل والحياة؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق صراعات داخلية وصراعات بينية تُولِّد المعاناة في النفس والجسد.
إن تحقيق مطلب الطفولة الآمنة والمستقرة لا يأتي اعتباطًا، وإنما من خلال كفاءات تربوية تُحدَّد من قبل المختصين في الجانب التربوي والنفسي والاجتماعي والصحي، ومن ثَمَّ، إكسابها للمتزوجين قبل ولادة الأبناء، وعمل ما يشبه الاختبار التربوي المهني للاجتياز والحصول على الرخصة التربوية. ولا يُترك الأمر عشوائـيًا نظرًا للمآسي المترتبة على التربية غير المدروسة وغير المخطط لها.